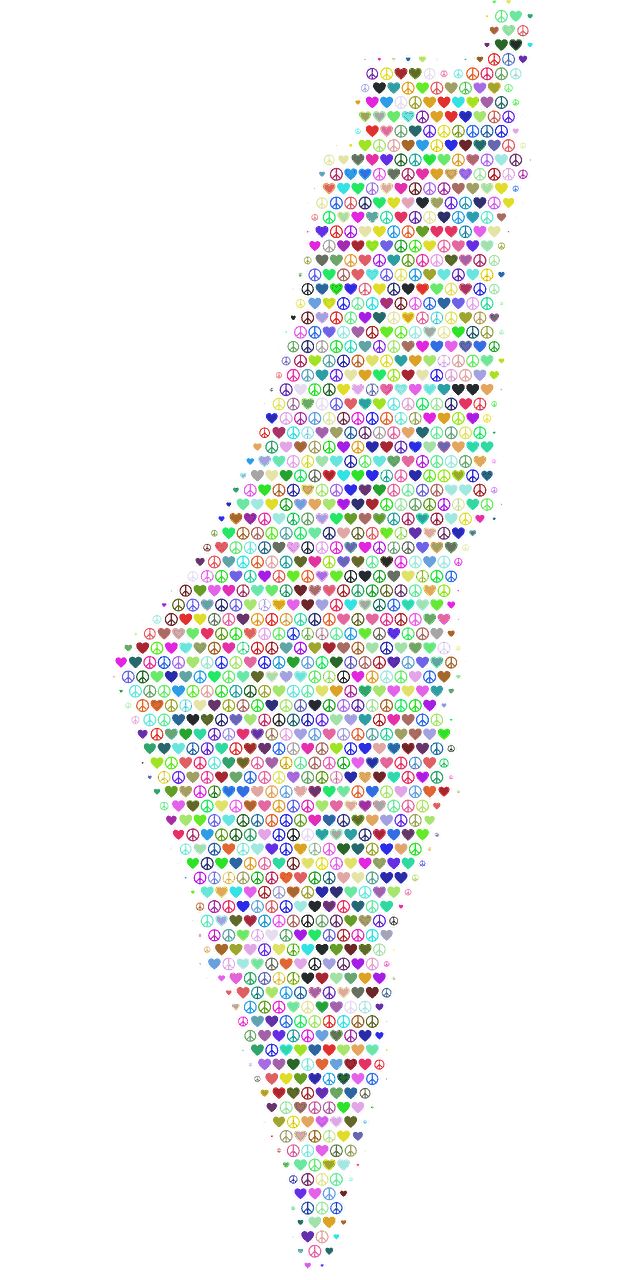ما الذي يجعل قتل ليليان في السويداء يبدو وكأنه حدث عابر؟ كأنه خطأ فردي أو تجاوزٌ يمكن استيعابه في سياق ثقافة محلية؟ السؤال هنا ليس عن الجريمة بحد ذاتها، بل عن المجتمع الذي أنتجها واستقبلها كجزء من نسق معتاد، لا يثير غضبه الحدث إلا للحظات قبل أن يعود إلى مساره المألوف. لا تُقتل النساء في لحظة غضب طارئة، وإنما ضمن سياق طويل من الترويض والقهر والإخضاع. القتل هنا ليس حدثاً، بل هو ذروة منظومة متكاملة تبدأ من اللغة، من التربية، من النظرة إلى المرأة ككائن قابل للتملك، للتأديب، للإلغاء عند الحاجة.
السوريون اليوم، وهم يحاولون بناء ما يسمى بالدولة الحديثة بعد هروب الطاغية، يكتشفون أن الاستبداد لم يكن مجرد جهاز سياسي، بل بنية ثقافية واجتماعية تتغلغل في العلاقات اليومية، في شكل العائلة، في حضور الرجل وغياب المرأة، في التشريعات كما في الأعراف، في الذاكرة كما في الطموح. هروب رأس النظام لم يسقط بنية العنف، بل كشف هشاشة التصورات التي كانت تختبئ خلف شعار إسقاط السلطة. السلطة لم تكن قصراً جمهورياً، بل كانت دائماً في المنزل، في الشارع، في المدرسة، في العقل نفسه.
الأخطر في المشهد طبعاً ليس وقوع الجريمة، ولكن الطريقة التي يتم بها استيعابها واحتواؤها من قبل المجتمع. استيعابٌ يستند إلى إرث من التبرير، من تحميل الضحية مسؤولية موتها، من منح الجلاد حق الدفاع عن “شرفه”، من تواطؤ صامت يبرر كل ذلك بدعوى “الخصوصية” أو “الاستثناء الثقافي”. هذه التبريرات امتدادٌ للعقلية ذاتها التي تجعل من القتل خياراً مشروعاً، أو على الأقل “قابلاً للنقاش”. ما الذي يمكن أن يُبنى فوق أرضٍ لا تزال ترى في جسد المرأة مساحةً للنزاع، وفي وجودها تهديداً للنظام الاجتماعي؟ كيف يمكن لحديث المواطنة والمساواة أن يتجسد في مجتمعات لم تحسم بعد ما إذا كانت المرأة فرداً كاملاً أم امتداداً لغيرها؟
ثم جاءت الصفعة الأشد وضاعة: تقرير طبي يقيس شرف امرأة على طاولة المستشفى، وجمهور من المعلقين ينتقلون من دور المتعاطفين إلى موقع القضاة، وكأن العذرية أصبحت فجأة الفيصل بين براءتها واستحقاقها للموت. هذه هي الحقيقة التي لا يريد أحد مواجهتها. ليس الشرف هو المشكلة، بل استعداد المجتمع لنبش الأجساد الميتة بحثاً عن مبرر، لرمي الاتهامات على ضحية لم يعد لها صوت تدافع به عن نفسها. كل ذلك يحدث بلا خجل، بلا تردد، وكأن الفجيعة تحتاج إلى شهادة طبية لتُقبل أو ترفض، وكأن حياة الإنسان ليست حقاً في ذاتها، بل معادلة توازن بين الأخلاق المفترضة وتوقعات الجماعة.
حين يتحدث البعض عن إعادة بناء سوريا، يغفلون أن التغيير لا يبدأ من إعادة ترتيب الوزارات والمؤسسات، بل من مساءلة كل علاقة سلطة قائمة في الحياة اليومية. الدولة الحديثة يجب أن تتخلص من العقليّة التي تُخضِع المرأة لسلطة الأب والأخ والزوج، وفي ظل وعي يرى في العنف وسيلة ضرورية لضبط المجتمع. الحديث عن الحقوق الفردية في مجتمع يحكمه نظام الولاءات الطائفية والعشائرية لا يبدو سوى رفاهية فارغة.
لا يمكن تجاوز هذه المرحلة دون تفكيك ما تراكم عبر عقود من القهر. ليست القضية في تبديل القوانين فقط، بل في تغيير العقول، في زعزعة المسلّمات، في فضح الأساطير التي تُبقي هذا المجتمع حبيساً لأشباحه. كل محاولة للالتفاف على هذه القضايا بحجة “الأولويات” ليست سوى تأجيل لمواجهة حتمية. سوريا الجديدة لن تكون إلا حين تصبح حياة الأفراد، أياً كانوا، غير خاضعة للمساومة.
لا يمكن اعتبار الجريمة التي أودت بحياة ليليان حدثاً طارئاً في حياة مجتمع مأزوم، إنما هي جزءٌ من نظام لا يزال يعمل بكفاءة. نحن نعيش في مجتمع يحتاج للتطوير وتحديث أفكاره، يجب أن يرفض قتل أبناءه بيديه ويتوقف عن البحث عن أعذار رخيصة لتبرير القتل، وأن لا يختبئ خلف التقاليد حين تُصبح المواجهة ضرورة، وأن لا يلوذ بالصمت حين يكون الكلام موقفاً ضرورياً. الصدمة لم تعد كافية، لأننا تعلمنا كيف نعيش مع الجثث ونتأقلم مع اللعنات. السؤال ليس عن القتلة، فهؤلاء كثر، بل عن كل من يقبل بأن يكون شريكاً بالصمت، بالتبرير، بالمراوغة. ليليان قُتلت، والسؤال اليوم ليس كيف ماتت، بل كيف استطعنا أن نعيش بعدها كأن شيئاً لم يكن.