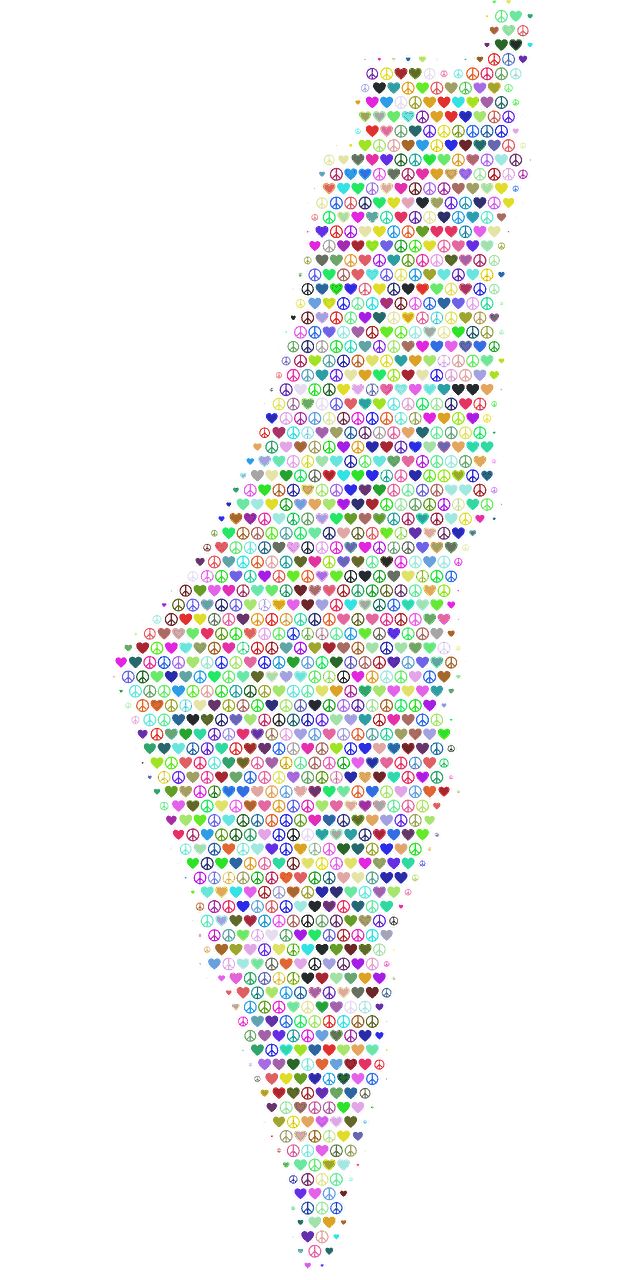أحمد البرهو
في مؤلّفه “الكلمات والأشياء” يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو إنّ بإمكان أحدنا -لو كان بمفرده في البرّيّة- أن يمنح للكلمات الدلالات التي يشاء، دون أن يقول له أحد: صدقت أو كذبت، صحيح أو خاطئ، لكنّ الأمر سيتغيّر أثناء ممارسة خطاب، ما يعني وجود آخر معني بالدلالة المشتركة.
إذن فالاهتمام بالحقيقة يُزامن الاجتماع البشري، وفوكو -في مرحلة متأخرة من التاريخ- درس “الحقيقة” من جهة معرفتها، فبدا التاريخ حقباً متتاليّة من عمليّات الوعي الإنساني للحقيقة، وبدا الفارق الجوهري بين حقبة حضاريّة وأخرى فارقاً في وعي “الحقيقة” وتمثّلات ذلك الوعي.
لكن أين الحقيقة؟
المثاليّون وعلى رأسهم أفلاطون مالوا إلى اعتبار الواقع زائفاً، واعتقدوا أنّ الحقيقة عقليّة تكمن في المثال، فيما مال الواقعيّون، وعلى رأسهم أرسطو إلى احتواء الواقع على “جوهر” الحقيقة بعد نفي الأعراض، ومن ثمّ بدت “الحقيقة” هويّة تحدث كلّما طابق الفكر الواقع.
وظلّ المنطق الأرسطي “التصورات والتصديقات” مهيمنا على الوعي البشري قروناً طويلة كانت خلالها الكتب المقدّسة مصدر تلك الحقيقة، والمنطق الأرسطي أداة وعيها، ما جعل من الموروث المقدّس -على اختلاف تعييناته لموضوعة الحقيقة- يترك مشتركات بين أتباع الديانات في طرق وعي الحقيقة ومعالجتها، ولعلّنا نمر على مشتركين اثنين.
الأوّل: لم تكن الحقيقة موضوعاً ماديّا، بل روحي مرتبط بالمطلق -الله- ويُمارَس ضمن سياقات “الخير والشّر”، ما يعني هيمنة النزعة المثاليّة.
الثاني: أنّ مسار وعي الحقيقة عبر منطق أرسطو -التصورات والتصديقات- كان وسيلة قارئ النصّ لتعيين ما الحقيقة في الواقع. فحظي قرّاء المقدّس على امتياز تفسيرها، ثمّ ادّعاء حيازتها كسلطة.
في السياق الروحي قدم “مارتن لوثر تـ 1546” نقدا لادّعاء حيازة الحقيقة الروحيّة، وعُرفت حركته لاحقا بـ “البروتستانتيّة”، وفي حين تعرّض المنطق الأرسطي ذاته إلى انتقادات كثيرة على يد علماء مسلمين ومسيحيين إلّا أنّ ذلك المنطق لقي مصرعه على يد “فرنسيس بيكون تـ 1626” بعد إنجاز بيكون كتابة “الأورغانون- المنطق الجديد”، ودعا إلى إعادة إخضاع المعارف القديمة لـ “الملاحظة والتجريب”، فعادت النزعة الواقعيّة، وأعطيت الذّات الإنسانيّة دوراً في اكتشاف الحقيقة.
في سيرورة التجديد جرى إعادة تقييم الحقيقة الروحيّة بإعادة قراءة المقدّس، وسارت جنباً إلى جنب مع تطوّر المعرفة بالحقيقة الماديّة التي خضعت لـ “الملاحظة والتجريب”، وأحدث التجديد الروحي والمادي أثره على السياقات الاجتماعيّة: الثقافيّة والسّياسيّة: فلمّا كانت الحقيقة الرّوحيّة – التي كان متعذّرا على غير النخب تعيينها- محور الاجتماع القديم، وباعث الشكل السّياسي للدولة الإمبراطوريّة، فإنّ “الحقيقة الماديّة” التي يمكن للأفراد العاديين تعيينها، ستكون محور الاجتماع المدني الجديد، ومن ثمّ أصبح الإنسان الحر -بطبيعتيه الروحيّة والماديّة- مركز تلك الحقيقة، والمُنتج لها.
مال القائلون بالطبيعة الإنسانيّة الشريرة، وعلى رأسهم “هوبز تـ 1679” إلى تقييد تلك الحريّة في مستواها الاجتماعي- المدني، ومال القائلون بإمكانيّة أن تصبح الطبيعة خيّرة – وعلى رأسهم “لوك تـ1704” إلى عدم تقييد تلك الحريّة في الفضاء الاجتماعي الجديد، واستمرّت الفلسفة الاجتماعيّة بالبحث في تعيينات الواقع للحقيقة، فالحقيقة ما يدركه الذهن بالفطرة لدى ديكارت، وهي حاصل التجربة لدى لوك، وهي مطابقة الفكر لموضوعه لدى فيلسوف مثل كانط الذي حاول الجمع بين النزوعين: العقل المحض والتجريب؛ فالواقع يزودنا بمادة الحقيقة والعقل يزودنا بصورتها بحسب كانط.
ورغم أنّ انهيار المنطق الأرسطي، في مرحلة سابقة، كان قد أعاد موضوع الحقيقة إلى التناول، إلّا أن القرن التاسع عشر شهد إنجاز العديد من “نظريّات المعرفة”، ما أسهم في إعادة تأطير “الحقيقة” ضمن أنماط معرفيّة بعينها، ولعلّ أحد أهم تلك الأنماط تولّد من الدمج الكامل بين العلوم الإنسانيّة والماديّة، ورصد حركة المادة بوصفها قوانين “ديالكتيك” حتمي يجري على الإنسان والمادة بصورة واحدة، وبذريعة “الحقيقة العلميّة الموضوعيّة”، تقلّص دور الذّات الإنسانيّة، وأصبح “العِلم” مركز الحقيقة، وعادت “النخب العارفة” لتمارس مركزيّة جديدة.
ارتبطت حقبة ما بعد الحداثة بالصدمة تجاه الحداثة ذاتها، لكنّ ما بعد الحداثة حافظ على “الديالكتيك” كآلة وعي للحقيقة، دون بُعد أخلاقي، فبدت الحقيقة لدى فيلسوف كـ”نيتشة ت1900″ مرتبطة بالقوّة، ولا شيء غير القوّة.
نشأت “البنيويّة” كمنهج نقدي عِلمي متأثرة ببحوث اللغوي السويسري “دوسوسير تـ 1913” لا لتعيّن ما الحقيقة إنما لدراسة النظام اللغوي -البناء- الذي تجري فيه “الحقيقة- المعنى”، فيما ظهرت فلسفات كـ “الظاهراتية والتأويليّة” لدراسة الحقيقة أو تأويلها ضمن الظاهرة -الكينونة، لكنّ فلسفة “هيدغر تـ 1976” توصلت إلى استحالة الإحاطة بـ “الكينونة”، فما إنْ تحاول اللغة رصدها حتى تتحوّل تلك الكينونة في تزامن مستمر، ونزع هيدغر إلى اللغة بوصفها بقيّة الكينونة.
وظهرت “التفكيكيّة” على يد “دريدا تـ 2004″، متأثرة بفلسفة هيدغر، لتعالج “الحقيقة – المعنى” بوصفها موضوعاً لغويّا خاضعاً للتناص المستمر، والإرجاء، حيث المعنى المفتوح.
ورأى “فوكو تـ 1984” الحقيقة متعددة بتعدد أشكال الخطاب، فلكلّ خطاب دلالاته، ودعا إلى “إعادة النظر في المعرفة، بإعادة صبغة الحادث إلى الخِطاب، وتجريد الدّال من كلّ دلالة”؛ ما دفع بفيلسوف مصري كـ “عبد الوهّاب المسيري تـ 2008” إلى إعلان قلقه بشأن الدلالات المفتوحة، والحقيقة غير الخاضعة لضابطة في غياب أيّ من مراكزها “الله، الإنسان، العِلم”.
ورغم غياب المركز فالعالم اليوم – نتيجة التطور في تقنيات التواصل- يبدو كقرية صغيرة، لكنّها أيضاً بريّة تجاذب الأفراد نحو ما بعد الحقيقة، بالقدر الذي تجاذبهم خلاله نحو ما قبل الحداثة والمفاهيم المدنيّة، حتى ليمكن أن تظهر، في الحيّز الزماني والمكاني الواحد، أساليب وعي الحقيقة جميعها، فيستعيد الأصولي منطق أرسطو لبناء هويّة، والإنسانوي وعي جون لوك، والمادي وعي هيغل أو ماركس، والنازي وعي نيتشة، والقلقون من ذلك كلّه وعي سارتر ودريدا، فيما يقطن الجميع في مبنى واحد.
ولا يزال السؤال قائما عن الشكل الممكن لهذا الاجتماع.